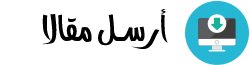تصفح باقي الإدراجات |
1  2 2  3 3  4 4  5 5  6 6  7 7  8 8  9 9  10 10  11 11  12 12  13 13  14 14  15 15  16 16  17 17  18 18  19 19  20 20  21 21  22 22  23 23  24 24  25 25  26 26  27 27  28 28  29 29  30 30  31 31  32 32  33 33  34 34  35 35  36 36  37 37  38 38  39 39  40 40  41 41  42 42  43 43  44 44  45 45  46 46  47 47  48 48  49 49  50 50  51 51  52 52  53 53  54 54  55 55  56 56  57 57  58 58  59 59  60 60  61 61  62 62  63 63  64 64  65 65  66 66  67 67  68 68  69 69  70 70  71 71  72 72  73 73  74 74  75 75  76 76  77 77  78 78  79 79  80 80  81 81  82 82  83 83  84 84  85 85  86 86  87 87  88 88  89 89  90 90  91 91  92 92  93 93  94 94  95 95  96 96  97 97  98 98  99 99  100 100  101 101  102 102  103 103  104 104  105 105  106 106  107 107  108 108  109 109  110 110  111 111  112 112  113 113  114 114  115 115  116 116  117 117  118 118  119 119  120 120  121 121  122 122  123 123  124 124  125 125  126 126  127 127  128 128  129 129  130 130  131 131  132 132  133 133  134 134  135 135  136 136  137 137  138 138  139 139  140 140  141 141  142 142  143 143  144 144  145 145  146 146  147 147  148 148  149 149  150 150  151 151  152 152  153 153  154 154  155 155  156 156  157 157  158 158  159 159  160 160  161 161  162 162  163 163  164 164  165 165  166 166  167 167  168 168  169 169  170 170  171 171  172 172  173 173  174 174  175 175  176 176  177 177  178 178  179 179  180 180  181 181  182 182  183 183  184 184  185 185  186 186  187 187  188 188  189 189  190 190  |
|
أحدث المقالات |
الاقتصاد في الإسلام - الجزء 6 فتحي الزّغـــــل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي فتحي الزّغـــــل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4720  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط … أمّا الأساس الخامس لمنظومة الاقتصاد في الإسلام، فهو اقتصار الضّريبة على الأغنياء فقط دون غيرهم من سائر الطّبقات الاجتماعيّة. الأساس الذي لا وجود لمثله أو لشبيهٍ له في أيّ منظومة اقتصاديّة بشريّة ، بل إنّه و بوجوده في أيّ مجتمع، يمكن لنا القول عليه بأنّه يطبّق تعاليم الدّين الإسلامي و تشريعاته في المجال الاقتصادي. لأنّ هذا الأساس هو ركنٌ من أركان الدّين الخمسة، علاوةٌ على أنّه أساس من أساسات المنظومة الاقتصاديّة الإسلاميّة سأتناوله على هذا التصنيف. و أنّ تطبيقه في معاملات الفرد المسلم الاقتصاديّة و في معاملات المجتمع الاقتصادية أيضا، هو إتيان لركن من أركان الإسلام الذي لا يقوم إلا به. و أقصدُ بهذا الأساس "الزّكاة": و هو ضريبة فرضها الإسلام على من يجمع مالًا يزيد على نفقات صاحبه، وهو ما يُعبَّرُ عنه في الفقه بـــ "النِّصاب"، إذا بقي ذلك المال عنده عاما كاملا دون نقصان يُخفّضه إلى ما دون النّصاب. و هي مُحدّدةٌ بمقدار ربع العُشٌرِ أي اِثنان و نصف في المائة، و ذلك في كلّ الحالات و الأزمنة و الأمكنة. بشكل يختلف تماما مع الجداول التّصاعديّة لنسبة الضّرائب المعروفة في الاقتصاد الكلاسيكي. إذ لا وجود في الإسلام لزيادة تلك النّسبة الواجب دفعُها أو إخراجُها كلّما زاد المالُ المجموعُ طيلة العام. و قد أثبتت عديد الدّراسات الاقتصاديّة الأكاديميّة غير التّجريبية في بعض الجامعات الغربيّة العريقة و المنشورة في صفحاتها الرّسميّة على شبكة الإنترنت كجامعة "هارفرد" بالولايات المتّحدة الأمريكيّة و جامعة "كامبريدج" البريطانيّة، أنّ ثبات نسبة الضّريبة في الإسلام لها تأثيرٌ مباشر في تدفّق الاستثمار و تطوّره، و نمو حجم الدّورة الاقتصادية ككلّ. و أنّ نسبتها القليلة (2.5 بالمائة ) مقارنة مع بعض النّسب الّتي تصل إلى 35 بالمائة في بعض الحالات، من شأنها أن تكون حافزا على العمل و الإنتاج، لقطعها التّامّ مع فكرة الدّفع الاِنصياعي لجزءٍ هامٍّ من ثروة الفرد تحت مسمّيات الضريبة على الدّخل. ....و لفهم عبقريّة هذا الأساس و ليتبيَّن لنا مدى صلاحه للفرد و للمجتمع ، يكون من الواجب أن نقارن بينه و بين مثيله في المناهج الاقتصادية المعروفةِ،. ففي النّظام الضّريبي الكلاسيكي يدفع كلُّ ذي دخلٍ ضريبةً على دخله تسليما أو اقتطاعا من أجره، و لو لم يكن قد أبقى شيئا من دخله ذاك عند نهاية عامه. بخلاف الأمر في المنظومة الاقتصاديّة الإسلاميّة التي تعفي هؤلاء من دفع الضريبة و هي الزكاة. فالموظّفون و العمّال و صغار الحرفيين و صغار التّجار و صغار الفلاّحين و أصحاب المهن ذات الدّخل القليل، يُكوِّنُون شريحة اجتماعيّة كبيرة في أيّ مجتمع. و يعيشون على دخلِهم الذي يكون في الغالب شهريّا و في بعض الأحيان موسميّا، بطريقة لا تبقى لهم مدّخرات لديهم طيلة سنة كاملة، بالنّظر إلى قلّة دخلهم و تواضعه، كما إلى تناسب ذلك الدّخل ومستوى معيشة مجتمعاتهم. و هم حتّى إذا ما نجحوا في اِدّخار شيءٍ من دخلهم لسنة كاملة، فإنّ مقدار تلك المدّخرات لا تصلُ حدَّ النّصاب المفروض عليه الزكاة، أي الضّريبة في النّظام الاقتصادي الإسلامي. بخلاف الأمر في النّظم الاقتصادية الكلاسيكية أينَ يُفرَضُ نظام ضريبةٍ متدرّجٍ عامّ على كلّ ذوي الدّخل على دخلهم، مهما يكن مقدار ذلك الدّخل، و مهما تكن علاقة المناسبة بينه و بين مستوى المعيشة في المجتمع... و هنا يتبيّن لنا عمقُ الاختلاف بين النّظامين: فبينَما يَدفعُ كلّ أفراد المجتمع ذوي الدّخل في المنظومات الاقتصاديّة الكلاسيكية ضريبةً على دخلهم تتناسبُ تصاعديًّا مع مقدار دخلهم، يقتصر دفع الضّريبة في المنظومة الاقتصاديّة الإسلاميّة على الأغنياء فقط، و هم تحديدا الذين جمعوا مالًا بقي عندهم سنة كاملةً يزيد على حاجتهم في تلك السّنة، الضريبة التي لا تتناسب تصاعديّا مع مقدار مالهم المُدّخَرِ، بل هي ثابتة بنسبة قليلةٍ جدّا إذا ما قارنّاها بتلك النِّسب المعروفةِ في كلّ المنظومات الاقتصاديّة الغربيّة في كلّ الدّول و النُّظم.... و هو ما يمثّل بونًا شاسعا بين ما شرّعه الإسلامُ، و ما شرّعهُ البشرُ في نظريّاته في هذا المجال. و بتطبيق ركنِ أو أساس الزّكاة بالطّريقة التي عرضتُها، سيبرز في المجتمع – لا محالةَ - واقعا اقتصاديّا يتميّز بوفرة النّقد السّائل أو ما يُعبّر عنه بالسّيولة في كلّ أيّام السّنة أي على مدار السّنة، و ذلك نظرا إلى أنّ الزكاة يستوجبُ دفعُها عند اكتمال النّصابِ و بقائه سنة كاملة عند صاحبه، و اكتمال السّنة هذا يحدُثُ في كلّ يومٍ لاختلاف مبدئها من الأيّام حسب الأفراد و يوم اكتمال النّصاب لديهم، الأمر الذي يقطع مع ظاهرة اقتصاديّة معروفةٍ لأهل الذكر في المنظومات الاقتصاديّة الكلاسيكيّة، تُعرف بـــ "فترة كساد التّقويم" أو "فترة حساب الجمع"، و التي تكون عموما في الفترة الممتدة بين آخر كلّ سنة و بداية السّنة التي تليها. كما أنّ وفرة السّيولة هذه ترجع إلى أنّ صاحب المالِ المستوجِب للزكاة، لا يدفع عليه ضريبة مرتفعةً، و أنّ تلك الضّريبة لا تشملُ ما يصرفه لحاجته طيلة سنة كاملة. و بذلك، وإذا ما ربطنا هذا الرّكن و هو الزكاة، بما أنتجه من وفرة مالٍ، مع الرّكن السّابق و هو تحريم الكنز، و الرّكن الذي قبله أيضا و هو تحريم الاِشتغال بالعملة و التّجارة فيها، تظهرُ لنا معالم الدّورة الاقتصادية في المجتمع المسلم، دورةٌ لا تُبقي أيَّ فرصةٍ للمالٍ أن يتجمّع في يد مالكه و يركُدُ، بل تُجبِرُه على استثماره و إنفاقه داخل مجتمعه، دون أن يكون استثماره ذاك قائما على إحساسٍ بالغُبن أو بالدّفع الغصبِ ، باقتطاع ماله للدّولة أو للمجتمع، أو على إحساس بالمراقبة الدّوريّة لنشاطه، لأنّ دفع المسلم للزكاة هو دفعٌ بطواعيَّة يُكمّل من خلاله أركان دينِه، و لا يمارس به فقط واجبا أو شعيرةً في مجال خاصّ من مجالات حياته. و هو ما يُحيلُنا إلى فكرة السّكّة المزدوجة التي صوّرتها في أوّل هذا الكتاب لبيان أنّ كلّ المنظومة الاقتصاديّة في الدّين الإسلاميِّ لا تعدو أن تكون سوى قطارا يسير عليها، و أقصدُ منظومتي "الأخلاق" و "الرّقابة الذّاتيّة". ففي الاقتصاد الإسلاميِّ لا حاجة للدولة أن تُدقِّقَ في الحسابات التي يُدلي بها صاحب المال، لأنّ خشيته من خالقه أشدّ من خشيته على نقصان ماله، بعكس كلّ المنظومات الضريبيّة الأخرى أين تدور لعبة القطّ و الفأر بين المُصرِّحِ بالدّخل و الجهة الجامعة للضريبة عليه، مع ما يدرّ هذا الوضع لوحده من مالٍ، خاصّة إذا عرفنا قيمة تكاليف دواوين المُحاسبة و الحسبة و القباضة، من أجورٍ و موظّفين و مراقبين و محاسبين في كلّ مجتمعات اليوم و كلّ يومٍ. ...و لكن يمكن لسائل أن يتساءل عن مدى كفاية ضريبة الزكاة المنخفضة جدًّا لحاجات و نفقات المجتمع. و هذا ما سأتناوله في ما يلحق من تحليل.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:الإقتصاد، الإقتصاد الإسلامي،  11-09-2013 11-09-2013

 في مسألة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال في مسألة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال  إنذارات بمجتمع يهوي إنذارات بمجتمع يهوي أنا اللّص الذي عنه تبحثون أنا اللّص الذي عنه تبحثون  قراءة في المشهد الانتخابي البرلماني التونسي بعد غلق باب التّرشّحات قراءة في المشهد الانتخابي البرلماني التونسي بعد غلق باب التّرشّحات السّياسةُ في الإسلام السّياسةُ في الإسلام ماذا يقع في "وينيزويلّا"؟ حسابات الشّارع وموازين الخارج ماذا يقع في "وينيزويلّا"؟ حسابات الشّارع وموازين الخارج بعد تفجير شارع بورقيبة ... ألو... القائد الأعلى للقوات المسلّحة؟
بعد تفجير شارع بورقيبة ... ألو... القائد الأعلى للقوات المسلّحة؟ إلى متى تنفرد الإدارة في صفاقس بتأويل خاصّ لقوانين البلاد 2؟ إلى متى تنفرد الإدارة في صفاقس بتأويل خاصّ لقوانين البلاد 2؟  "التوافق" في تونس بين ربح الحزب وخسارة الثورة "التوافق" في تونس بين ربح الحزب وخسارة الثورة "ترامب"... رحمة من الله على المسلمين "ترامب"... رحمة من الله على المسلمين حكاية من الغابة... حكاية اللئيم و الحمير حكاية من الغابة... حكاية اللئيم و الحمير بقرة ينزف ضرعـــها دما بقرة ينزف ضرعـــها دما تعليقا على مؤتمر النهضة... رضي الشيخان ولم يرض الثّائر تعليقا على مؤتمر النهضة... رضي الشيخان ولم يرض الثّائر بعد مائة يوم على الحكومة... إلى أين نحن سائرون؟ بعد مائة يوم على الحكومة... إلى أين نحن سائرون؟ الغرب و الشّرق و "داعش" و "شارلي" الغرب و الشّرق و "داعش" و "شارلي" "الإرهاب و مسألة الظّلم" ج3 "الإرهاب و مسألة الظّلم" ج3 "الإرهاب و مسألة الظّلم" ج2 "الإرهاب و مسألة الظّلم" ج2 "الإرهاب و مسألة الظّلم" ج1 "الإرهاب و مسألة الظّلم" ج1 كيف تختار الرّئيس القادم؟ كيف تختار الرّئيس القادم؟ قراءة في الانتخابات البرلمانية التونسية قراءة في الانتخابات البرلمانية التونسية سكوتلاندا لا تنفصل... درس في المصلحيّة سكوتلاندا لا تنفصل... درس في المصلحيّة قراءة في النّسيج الانتخابي التّونسي قراءة في النّسيج الانتخابي التّونسي "أردوغان" رئيسا لتركيا... تعازي غلبت التهاني "أردوغان" رئيسا لتركيا... تعازي غلبت التهاني "غزّة" و الإسلاميّون "غزّة" و الإسلاميّون الانتخابات الفضيحة الانتخابات الفضيحة أُكرانيا و مصر و نفاق الغرب أُكرانيا و مصر و نفاق الغرب رئيسٌ آخر و حكومة جديدة.... قراءة في ما بعد الحدث رئيسٌ آخر و حكومة جديدة.... قراءة في ما بعد الحدث بيان بخصوص رفض الأطبّاء العمل في المناطق الدّاخليّة بيان بخصوص رفض الأطبّاء العمل في المناطق الدّاخليّة بيان بخصوص إضراب القضاة بيان بخصوص إضراب القضاة سلطتنا التّنفيذيّة وعلامات الاستفهام سلطتنا التّنفيذيّة وعلامات الاستفهام |
|||||||||




 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا
مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا
أنظر باقي مقالات الكاتب(ة) بموقعنا